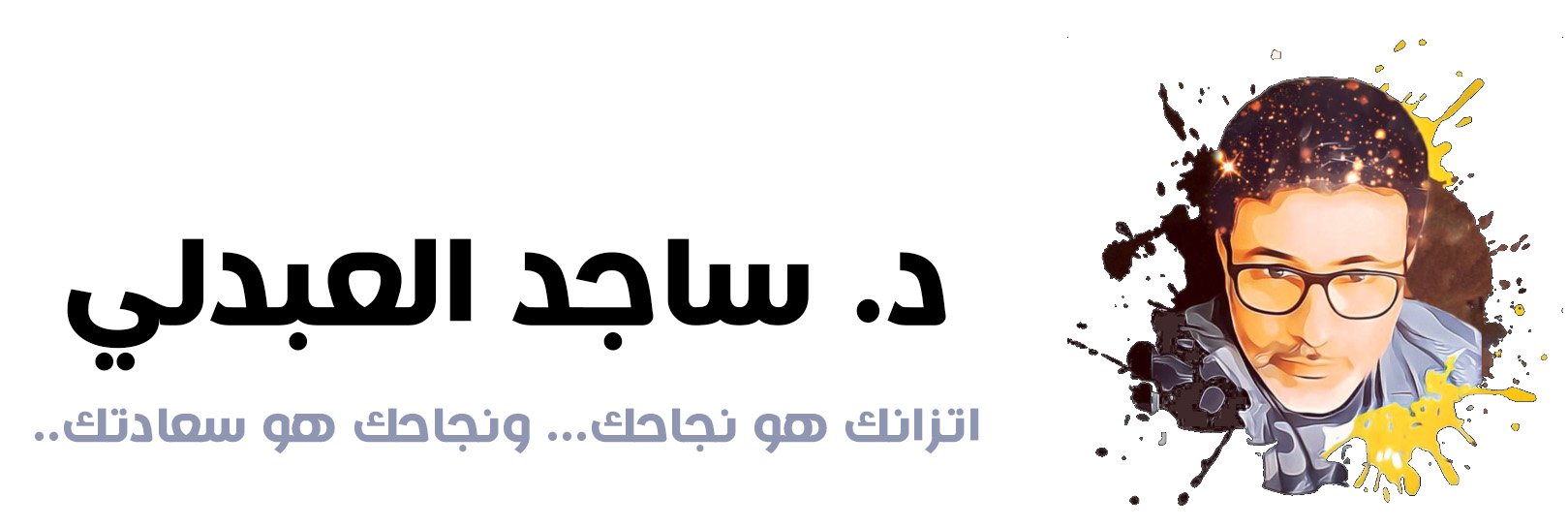ترجمة مقال، هل تخليت عن القراءة؟ للروائية التركية إليف شفق

كتبت إليف شفق مقالا في صحيفة الجارديان البريطانية (بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٥م) بعنوان: هل تخلّيت عن القراءة؟
قالت فيه:
تشير دراسات حديثة إلى أن حب القراءة قد تراجع، لكن كلما ازدادت فوضى عالمنا، زادت حاجتنا إلى التمهّل وقراءة الأدب.
أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة يوغوف أن أربعين بالمئة من البريطانيين لم يقرؤوا أي كتاب خلال العام الماضي. كان فيليب روث قد تنبأ عام ألفين بنهاية العصر الأدبي، قائلاً: “الدليل هو الثقافة، والدليل هو المجتمع، والدليل هو الشاشة.” كان روث يعتقد أن نمط التفكير الذي يتطلبه الأدب سيختفي لا محالة، وأن الناس لن يكون لديهم بعد الآن التركيز أو العزلة اللازمة لقراءة الروايات.
وتبدو عدة دراسات وكأنها تؤيد استنتاج روث. فقد انخفض متوسط مدة تركيز الإنسان على مهمة واحدة خلال العقود الأخيرة من نحو دقيقتين ونصف الدقيقة إلى حوالي خمس وأربعين ثانية فقط. وقد لاحظتُ ذلك بنفسي عندما قدّمت محاضرتين في مؤتمرات تيد بفاصل يقارب عشر سنوات. ففي عام ألفين وعشرة طُلب منا أن نلتزم بمدة عشرين دقيقة للمحاضرة، أما في عام ألفين وسبعة عشر، فقد خُفضت إلى نحو ثلاث عشرة دقيقة. وعندما سألت عن السبب، أخبرني المنظمون أن مدى الانتباه لدى الجمهور قد تقلص. رغم ذلك، حافظت على حديثي بمدته الأصلية عشرين دقيقة. وبالمثل، أود أن أعارض الفكرة القائلة بأن الناس لم يعودوا بحاجة إلى الروايات.
والواقع أن نفس استطلاع يوغوف أظهر أنه من بين من يقرؤون، فإن أكثر من خمسة وخمسين بالمئة يفضلون الأدب القصصي. وإذا تحدثت إلى أي ناشر أو بائع كتب فسيؤكد لك الأمر: شهية الناس لقراءة الروايات ما تزال واسعة الانتشار. إن بقاء هذا النوع من الكتابة الطويلة في عالم تحكمه المعلومات الفائقة، والاستهلاك السريع، وعبادة الإشباع الفوري، هو معجزة حقيقية.
نحن نعيش في عصر يتوفر فيه الكثير من المعلومات، لكن القليل من المعرفة، وأقلّ من ذلك بكثير من الحكمة. هذا الفائض من المعلومات يجعلنا متعجرفين، ثم يخدّرنا. يجب أن نعيد التوازن، ونركّز أكثر على المعرفة والحكمة. ولأجل المعرفة نحتاج إلى الكتب، والصحافة المتأنية، والبودكاست، والتحليلات المتعمقة، والفعاليات الثقافية. أما الحكمة، فنحتاج إليها عبر أشياء متعددة، من بينها فن الحكاية. نحن نحتاج إلى الكتابة الطويلة.
لا أزعم أن كُتّاب الرواية حكماء. بل على العكس، نحن فوضويون إلى حد بعيد. لكن الشكل الطويل في الكتابة يحمل في طياته البصيرة، والتعاطف، والذكاء العاطفي، والرحمة. هذا ما قصده ميلان كونديرا حين قال: “حكمة الرواية تختلف تماماً عن حكمة الفلسفة”. وفي النهاية، فإن فن الحكاية أقدم وأكثر حكمة منّا نحن. يعرف الكُتّاب هذا الأمر في أعماقهم — وكذلك يعرفه القرّاء.
خلال السنوات الأخيرة، لاحظتُ تغيرًا في الفئات العمرية الحاضرة لفعاليات الكتب والمهرجانات الأدبية في بريطانيا: هناك تزايد واضح في حضور الشباب. بعضهم يأتي برفقة أهله، لكن الأغلبية تأتي بمفردها أو مع الأصدقاء. وهناك تزايد ملحوظ في حضور الشباب الذكور لفعاليات الرواية. يبدو لي أن كلما ازدادت فوضى الأزمنة، اشتدت حاجتنا إلى التمهل وقراءة الأدب. في زمن يموج بالغضب والقلق، وباليقينيات المتضاربة، وتصاعد النزعات القومية والشعبوية، يزداد الانقسام بين “نحن” و”هم”. لكن الرواية، على النقيض، تفتّت هذه الثنائيات.
السرد الطويل، منذ ملحمة جلجامش، ظل يلقي بسحره في صمت. فهذه الملحمة، التي تُعد من أقدم الأعمال الأدبية الباقية، عمرها لا يقل عن أربعة آلاف سنة، وتسبق في تاريخها كتابات أوفيد وهوميروس. وهي قصة غير معتادة، وبطلها غير مألوف. في هذه القصيدة، يظهر الملك جلجامش بروح قلقة، تثقل كاهله عاصفة قلبه. إنه شخص وحشي، أناني، مدفوع بالجشع والقوة وحب التملك. لكن الآلهة ترسل له رفيقًا: إنكيدو. ومعًا، ينطلقان في رحلات بعيدة، يكتشفان من خلالها أراضي جديدة — ويكتشفان أنفسهما كذلك.
إنها قصة عن الصداقة، لكنها أيضًا تدور حول أشياء كثيرة أخرى: قوة الماء والفيضانات في التدمير أو التجديد، رغبتنا في إطالة الشباب، وخوفنا من الموت. في معظم الأساطير الكلاسيكية، يعود البطل إلى وطنه منتصرًا — لكن ليس في ملحمة جلجامش. فهنا نجد بطلًا خسر صديقه العزيز، وفشل في معظم مهماته، ولم يحقق نصرًا واضحًا. لكن جلجامش، بعد أن خَبِر الفشل والهزيمة والحزن والخوف، يتحول إلى إنسان أكثر لطفًا وحكمة. إن هذه القصيدة القديمة تتحدث عن إمكانية التغيير، وعن حاجتنا لاكتساب الحكمة
منذ أن رُويت ملحمة جلجامش وتم تدوينها، تعاقبت إمبراطوريات كثيرة وزالت، واندثر ملوكٌ عظام — “رجال أقوياء” — وانهارت أضخم المعالم إلى غبار. ومع ذلك، نجت هذه القصيدة من أمواج التاريخ — وها نحن، بعد آلاف السنين، ما زلنا نتعلم منها. الملك جلجامش، بعد رحلاته وإخفاقاته، يتصالح مع هشاشته الداخلية وقوة تحمله. يتعلم أن يصبح إنسانًا. تمامًا كما نفعل نحن، حين نقرأ الروايات عن أناسٍ آخرين.